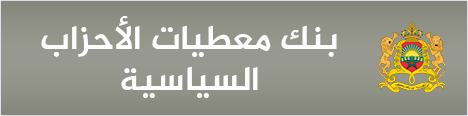كما فضل بطل الرواية، موسى، أن يدخل مرج الدوالي ليلًا؛ فضل عبد الحميد شوقي، أن يرغم القارئ، على دخول نصه -القديم الجديد- من ظلام الليل، الذي يرشح بغرابيب العتمة، تلك العتمة التي تقود ذهنك مباشرة، بتفاؤل، إلى ليل العشاق، أو ليالي السمر في بيوت الأحياء الشعبية؛ لرجال ونساء يبحثون في ذياك السمر عن وجه الحياة الأملس، بعد عذابات يوم منهك في البحث عن زاد للحياة.. أو يقودك، بسوداوية؛ نحو ذلك الليل الذي يكون عباءة اللصوص والقتلة، وغطاء للجلادين من زوار الفجر..
لتجد نفسك مبهمة، تتسائل عن نوع هذا الليل، وكينونة هؤلاء العائدين، الذي يضج بهم عالم الرواية الورقيّ والحبريّ، خلف دفتها، التي حملت مع العنوان رسما زيتيا لأحد الأزقة بالمدن العتيقة..
“ليل العائدين”..ليلٌ من الخيانة
خلف هذا العنوان البارد، كليل مرج الدوالي، يستدرجك عبد الحميد شوقي، إلى فخ التشويق، لتبدأ رحلة التورط في ليلٍ من الخيانة، الوفاء، الغدر، الشهامة، الحلم، الحب، المبدأ، البطولة، الشقاء والفرح.. ليل “موسى” الذي عاد إلى «مرج الدوالي»، بلا عصاه، غارقا في لجج الصمت، بعدما أسكته هدير بحر الخيانة، النذالة، الدمامة والدناءة، التي تفرخت من رحم الحسد والغيرة، وكبرت وتضخمت في نفس ذياك الـ“موسى” حتى رمته في أحضان “فرعون” وسحرته..
في هذه الرواية؛ -التي تعتبر باكورة الروائي الشاعر، التي لم يكتب لها أن ترى النور، إلا هذا العام 2018، عن دار العين المصرية، رغم أنها كتبت قبل “سَدُوم”، النص الذي نشر سنة 2015، عن دار الآداب اللبنانية-، يستعيد الكاتب تخييليًا، وبلغته الجذلى الجذابة، فترة شائكة من تاريخ المغرب، تلك الفترة المتلفعة بالجمر، والمتشحة بالرصاص، والملتحفة عتمةً وسوادًا، لما حملته من مآسي تراجيدية، إكتوت وتلظت بنارها كل مناطق المغرب، لكنه يستعيدها بشكل مغاير للمألوف أدبيًّا، وإذ نستعمل مفردة (تخييليا) فذلك لا يعني أننا نفند وجود أحداث حقيقية في النص، وإنما لأننا نعتبر أن مساءلة نص أدبي ما، عن كمية مسحوق الخيال والحقيقة في طبخته، غير صائبة البتة، ولا تخلوا من فعل عبثي نمارسه بجهل يشوه جمالية الأدب، التي تشكل منطقة تماهي الواقع بالخيال، ليصبح كل منهما هو الآخر “الواقع خيالًا، والخيال واقعًا”، يمشي بحذائه ويحذوا حذوه..
وبـ“بوليفونية”، يكسر نص “ليل العائدين” السائد في نمط تلك النصوص، التي أماطت الحجب عن عورة «سنوات الجمر والرصاص»؛ والتي ظلت تلعن الجلاد، وتشجبه بلغة بكائية حزينة، تدينه أكثر من فضحه في أغلبها، بل ملأ الفراغ المتواجد في رفوف الأدب المغربي، إذ يسترد فيه الصوت المغيب عمدًا أو سهوًا للخونة والمخبرين، الذين باعوا القضية بأبخص الأثمان وكانوا فيها من الزاهدين.. وأعطى لتلك الفئة مساحة لتتكلم، وتبوح بالكثير من الصور التي تحمل في تلافيف ذَاكرتها، كيف كان النظام الديكتاتوري يدير لعبة السياسة بالقمع في المغرب، كيف كان يتعامل مع الأصوات المعارضة والمغردة خارج السرب المخزني، بل كيف كان يخترق التنظيمات السرية، ويجهض الأحلام وهي قيد تشكلها، ويخرج الخطر من مأمنها بعبعًا مقيتًا، من حيث تدري ولا تدري..
“ليل العائدين”، نص آسر آسي، بلغته وصوره التي استطاعت رسم عالم مضحك مبكي في الآن معا، تلك اللغة التي تكاد تكون نادرة في الرواية المغربية؛ اللغة متعددة الأصوات التي سماها فَقِيه اللغة، الروسي “ميخائيل باختين” باللغة “البوليفونية”، التي ظهرت كشكل جديد في الرواية الحديثة؛ شكل لا يعترف بالتابو والتوتم، ولا بالمقدس ولا المطلق، بل يعتبر كل شيء نسبيًا وغير مكتمل.. ويظهر تعدد الأصوات في الحوارات بين شخوص الرواية، وحكايات شخوص النص بأصواتهم المتحررة من عقال السارد، كـ“نصيرة وموسى”، وفِي توظيف الدارجة وتداخلها بالفصحى، كما في عبارة (راجع من برَّا) ص12، التي أوردها الكاتب عن قصد، لعلمه أنه يضيء النص بلهجة البلد، فالرواية بنت الواقع والمكان، كما أنه يمغنط بذلك لسانين، وعيين وصوتين في نصه، ناهيك عن أن استعماله للفرنسية في مواضع مختلفة من النص، ويحيلنا ذلك إلى تلك اللغة التي بقيت عالقة في الألسن، التي خلفها المستعمر، بعدما فرضت على أهل البلد قسرًا، لتحييد هويتهم عمدًا، أو ربما يكون الكاتب بتوظيفها يتبنى موقف الكاتب الجزائري “كاتب ياسين”؛ الذي يرى أنها “غنيمة حرب”، وهنا أترك للنقاد المجال لدراسة ذلك واستقراءه، دون أن أتطفل على عالمهم الغريب، كما أترك للقراء متعة اكتشاف هذا النص، دون أن أحرق فصوله كما تعودت دائما..